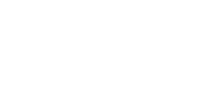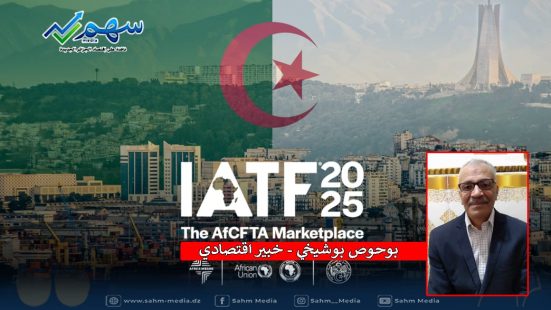تحدث الخبير في الأمن الغذائي والمائي، إبراهيم موحوش، في تصريح للجريدة الإلكترونية “سهم ميديا”، عن أهمية مشاريع تحلية مياه البحر في الجزائر، معتبرًا إياها خيارًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات المائية المتفاقمة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وشح الأمطار. وأكد أن تحلية المياه أصبحت ضرورة وطنية لضمان الأمن المائي واستقرار الزراعة، داعيًا إلى تبنّي مقاربة متوازنة تراعي خصوصيات كل منطقة وتجمع بين توسيع محطات التحلية شمالًا واستغلال الموارد الجوفية جنوبًا، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على الجدوى الاقتصادية للمزارع.
وأكد الخبير موحوش، أن الجزائر تقع ضمن واحدة من أكثر المناطق جفافًا في العالم، وهي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط المعروفة بعجزها المزمن في الموارد المائية. وأوضح أن الجزائر لا تملك سوى 12 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المتجددة، في حين تبلغ حاجتها نحو 64 مليار متر مكعب، ما يجعلها ضمن الدول الأشد فقرًا مائيًا عالميًا.
وأشار إلى أن الجزائر لجأت منذ نحو 20 سنة إلى خيار تحلية مياه البحر والمياه المالحة، وهو ما اعتبره “توجهًا استراتيجيًا” لمجابهة التغيرات المناخية وضمان استمرارية إمدادات المياه، مشيدًا بتحقيق البلاد لإنجاز لافت من خلال 19 محطة تحلية تغطي 42% من احتياجات الماء الشروب، مع توقعات ببلوغ 72% بحلول عام 2030 بعد استكمال 6 محطات جديدة.
كما أبرز أن هذه القفزة التقنية تحققت بفضل كفاءات وطنية شابة، تم تكوينها في الجامعات والمدارس العليا الجزائرية، ما يُعد، حسب وصفه، “معجزة حقيقية” بالنظر إلى أن الجزائر قبل عقدين فقط لم تكن تمتلك أي خبرة في هذا المجال، وأصبحت اليوم ضمن الدول الأولى عربيًا وإفريقيًا من حيث الإنتاج.
ارتفاع تكلفة التحلية يحدّ من استعمالها الزراعي… والتوجه جنوبًا هو البديل
وأوضح موحوش أن تكلفة تحلية المياه لا تزال مرتفعة، إذ يتطلب إنتاج المتر المكعب الواحد أكثر من 200 دينار جزائري، مما يجعل استخدامها في النشاط الزراعي غير مجدٍ اقتصاديًا، باستثناء بعض الزراعات ذات القيمة العالية والمخصصة للتصدير، أو التي تدر هامشًا ربحيًا كبيرًا.
وبيّن أن القطاع الزراعي يستهلك بين 75 إلى 85% من الموارد المائية، بينما تستهلك مياه الشرب نسبة لا تتجاوز 5%، وهو ما يجعل من الضروري توجيه المياه المحلاة أساسًا للاستهلاك المنزلي أو الصناعي في بعض الحالات الاستثنائية.
وأكد أن الحل الأمثل لاستقرار الزراعة في الجزائر يكمن في التوجه إلى الجنوب الكبير، حيث توجد موارد جوفية هائلة تقدر بـ50 ألف مليار متر مكعب. ورغم أنها غير متجددة، إلا أن ضخامتها تجعلها خيارًا واقعيًا لسد احتياجات الزراعة في المناطق الداخلية والهضاب العليا.
دمج المياه المحلاة في الزراعة… خيار انتقائي حسب الجدوى الاقتصادية
كما أكد الخبير أن استعمال المياه المحلاة في الزراعة يجب أن يتم بشكل انتقائي ومدروس، مشيرًا إلى أن تكلفتها المرتفعة لا تسمح بتعميم استخدامها إلا في حالات نادرة، عندما يكون سعر بيع المنتج الزراعي أعلى من تكاليف الإنتاج، ما يحقق جدوى اقتصادية معقولة.
وأوضح أن استخدام المياه المحلاة يمكن أن يكون حلاً مؤقتًا لتجاوز فترات العجز الحاد في المياه، خصوصًا في المواسم التي تشهد شحًا في الأمطار أو جفافًا استثنائيًا. وفي هذه الحالة، تُستخدم المياه المحلاة بشكل محدود لتغطية الاحتياجات العاجلة إلى حين استعادة الموارد التقليدية.
وأشار موحوش إلى أن الاستراتيجية المثلى لدمج المياه المحلاة في الزراعة يجب أن تراعي التوازن بين الكلفة والعائد، مع التركيز على الزراعات ذات الربحية العالية، مؤكدًا أن تعميم هذا الخيار دون دراسة الجدوى الاقتصادية قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين.
الحلول ليست حصرية… والاستثمار المتوازن بين الشمال والجنوب هو المفتاح
قال موحوش إن تعميم محطات التحلية على كامل التراب الوطني ليس خيارًا واقعيًا بسبب التكلفة الباهظة لهذه المحطات، حيث تبلغ تكلفة إنشاء محطة واحدة بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا نحو 700 مليون دولار، وهو ما يعادل 100 مليار دينار جزائري، مما يستدعي توجيه هذا الاستثمار نحو المناطق التي تعاني شحًا شديدًا فقط.
وأوضح أن الأولوية في المناطق الجنوبية ينبغي أن تُمنح لتعبئة الموارد الجوفية واستصلاح الأراضي الزراعية، إلى جانب توفير البنية التحتية الأساسية كالكهرباء والإنترنت، ما يسمح باستقرار السكان وتوسيع النشاط الفلاحي بشكل متكامل.
وختم بالتأكيد على أن الحلول الناجعة تكمن في “الجمع بين المسارات”، أي المزاوجة بين تعميم محطات التحلية في الشمال والهضاب العليا، وبين تعبئة الموارد المائية وتنمية الزراعة في الجنوب، بما يتناسب مع خصوصيات كل منطقة والوسائل المتاحة لكل جهة.