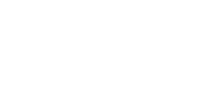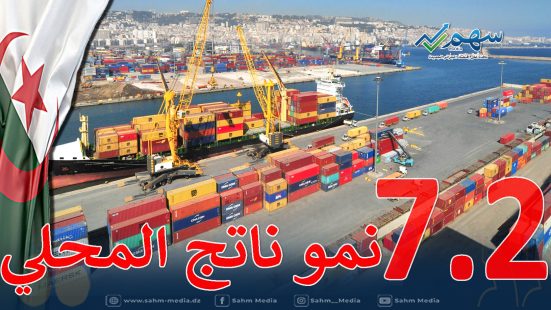أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، بحر هذا الأسبوع، عن قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، استنادًا إلى توجيهات الملك محمد السادس، مبررة ذلك بالتحديات المناخية والاقتصادية التي أدت إلى تراجع أعداد الماشية.
القرار، الذي أُعلن على بعد أشهر قليلة من عيد الأضحى، أثار جدلًا واسعًا بين من يراه ضرورة مؤقتة فرضتها الأوضاع الراهنة، ومن يعتبره تدخلًا في الشعائر الدينية لا مبرر له، خاصة أن المغرب لم يسبق له أن ألغى هذه الشعيرة حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى.
ورغم أن الخطاب الرسمي يركز على فكرة “التخفيف عن المواطنين” وحمايتهم من الأعباء المالية في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي وتراجع أعدادها، إلا أن هذا الطرح يثير تساؤلات جوهرية حول حرية الأفراد في أداء الشعائر الدينية وفق إمكانياتهم، فالإسلام ينص على أن الأضحية سنة مؤكدة، فلماذا يتم اتخاذ قرار عام يشمل الجميع دون ترك الخيار لكل فرد وفق ظروفه؟ أليس من الأولى أن توفر الدولة دعمًا لمن لا يستطيع شراء الأضحية بدلًا من إلغائها تمامًا؟
لكن الجدل لا يتوقف عند البعد الديني فقط، بل يتعداه إلى زاوية أخرى تتعلق بالسياسات الزراعية والاقتصادية للمغرب. فبينما يُبرر القرار بتراجع أعداد الماشية بسبب الجفاف وتغير المناخ، يبرز تساؤل آخر حول كيفية إدارة الدولة لمواردها الطبيعية. هل كان من الحكمة اللجوء إلى إلغاء شعيرة دينية متجذرة في المجتمع المغربي، أم أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب استراتيجيات فعالة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والتخفيف من آثار الجفاف؟
وفي هذا السياق، يتجدد الجدل حول السياسات الزراعية للمملكة، خاصة مع تصاعد الأصوات المنتقدة للعلاقات الزراعية بين المغرب والكيان الصهيوني، والتي تشمل استثمارات زراعية مكثفة في مشاريع مثل زراعة الأفوكادو، المعروف عالميًا بأنه من أكثر المحاصيل استنزافًا للمياه. فمن المفارقات أن الدولة التي تدعي أن الجفاف يمنعها من السماح بذبح الأضاحي، تُبرم اتفاقيات زراعية ضخمة مع شركات إسرائيلية، تشمل زراعات تستهلك كميات هائلة من المياه، في وقت يواجه فيه المغاربة أنفسهم شحًا متزايدًا في الموارد المائية.
ووفقًا لتقارير بيئية، فإن زراعة الأفوكادو تستهلك ما بين 600 إلى 1000 لتر من المياه لكل كيلوغرام واحد، وهي نسبة مرتفعة جدًا بالمقارنة مع المحاصيل الأخرى. ومع ذلك، تستمر الحكومة في تشجيع استثمارات زراعية مكثفة مع الاحتلال، متجاهلةً تأثير هذه المشاريع على المخزون المائي الوطني. فإذا كان الهدف الحقيقي من إلغاء الأضحية هو الحفاظ على الموارد، فلماذا لا يتم اتخاذ قرارات مماثلة تحدّ من الأنشطة الزراعية التي تساهم في استنزاف المياه؟
هذه الازدواجية في المعايير تجعل الكثير من المغاربة يتساءلون عن مدى مصداقية التبريرات الحكومية. فمن غير المنطقي أن يُطلب من المواطنين الامتناع عن شعيرة إسلامية بحجة الحفاظ على الثروة الحيوانية، بينما تُفتح أبواب الاستثمار على مصراعيها أمام مشاريع زراعية مكلفة بيئيًا، والأخطر من ذلك، أن هذه الاستثمارات تأتي من الكيان الصهيوني، في وقت تزداد فيه الأصوات المطالبة بوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.
الأمر لا يتعلق فقط بقرار ظرفي، وانما يُنذر بتوجه جديد قد يمهد لمزيد من التدخلات في الشعائر الدينية مستقبلاً، خاصة مع تصاعد سياسات الدولة في تقييد بعض الممارسات الدينية أو إعادة تفسيرها وفق اعتبارات سياسية واقتصادية. هل يمكن أن نشهد في المستقبل قرارات مماثلة تمسّ بشعائر أخرى؟ وهل يصبح تدخل الدولة في تفاصيل الممارسات الدينية أمرًا اعتياديًا كلما واجهت تحديات اقتصادية؟
إن هذا القرار، الذي يُسوق على أنه “رأفة بالمواطنين”، قد يكون في حقيقته مقدمة لتوجه أوسع نحو ضبط الممارسات الدينية وفق سياسات الدولة، بدلًا من تركها لاجتهاد الأفراد كما هو الحال في باقي الدول الإسلامية. وإذا كانت الحكومة تتحدث عن أولوية “رفع الحرج” عن المواطنين، فلماذا لا تبدأ بنفسها وتراجع سياساتها الاقتصادية والزراعية التي تثقل كاهل الفلاحين والمستهلكين على حد سواء؟
يبدو أن الجدل حول إلغاء شعيرة الأضحية سيتواصل طويلًا، بسبب تداعياته الدينية والاجتماعية، وأيضًا بسبب ما يكشفه من تناقضات صارخة في سياسات المخزن. فإما أن يكون الحفاظ على الموارد أولوية شاملة تُطبَّق على الجميع، بما في ذلك المشاريع الزراعية المستنزفة، وإما أن يكون قرار إلغاء الأضحية مجرد ذريعة لإخفاء مشاكل أعمق تتعلق بسوء التخطيط الاقتصادي والسياسات الزراعية الفاشلة.